
فالعالم اليوم يمتلئ باليقينيات على مختلف الصعد، كما يمتلئ بأسئلة الشك على مختلف المستويات. لذلك لا يمكن أن تموت الأسئلة في عالم يموج بالمتناقضات والتعقيد، فكل شيء في هذا العالم المعاصر، يؤسس على الدوام للأسئلة، ويستدعي الإثارة والبحث فلا مناص من السؤال والتساؤل، مهما بدا العالم متقدماً ومتطوراً. فالتساؤل هو اللاي يقوي الفكر على حد تعبير (هايدغر)، وهو سبيل الكشف عما تحجبه القوة أو المادة من حقائق ووقائع. والخطاب الغربي المعاصر، الذي يؤسس للتواريخ بعد موتها لا يلغي التساؤلات، ولا ينفي الدهشة، بل يؤكدها ويحفز على تأسيسها في كل المواقع والحالات، لأنه لا يمكن أن تمرر عناصر هذا الخطاب بدون نقد ومساءلة وتمحيص. ولا ريب أن كل تساؤل ينطوي على نقد، كما إن كل نقد يثير العديد من الأسئلة والتأويلات المتعددة. لهذا فإن إثارة الأسئلة على مسارات الواقع المختلفة من ضرورات الحياة والوجود، لأنه لا حقيقة ناصعة إذا لم تسبقها أسئلة الشك والنقد ورفع الحجب والأوهام. ففي رحاب السؤال والمساءلة، تتولد عناصر الحقيقة، واستمرار النقد يعني فيما يعني نمو الحقائق والأفكار والقناعات داخل المحيط الاجتماعي.
من هنا قيل إن العلم عبارة عن خطأ مصحح. فلابد من توسل السؤال والنقد، حتى ننجو من الزور والرياء والمخاتلة، وخطاب المطلق الذي يخفي الكثير، ولا يظهر إلا القليل والنادر.. وكل منظومة فكرية لا تقبل السؤال وتقمع النقد والمساءلة فإن مآلها السكون والموت.
نحن هنا لا ندعو إلى التشكيك في نوايا السائلين، وإنما نؤسس لمواقع السؤال والنقد في مسار الحقيقة وإثراء الفكر والمعرفة. لأن الكائن المتلقي دائماً، بلا أسئلة وشروط ونقد، نساهم معه أو نساعده على انتزاع عقلانيته، ونذوبه في أوعية متماهية ومتطابقة تقتل كل حس حيوي فيه وإرادته الإنسانية. فالكائن الإنساني، لا يمكنه أن يمارس إنسانيته وعقلانيته وشهوده، إذا لم يمارس السؤال والبحث المضني عن الأفكار والحقائق. ولا يوجد على صعيد الأفكار البشيرة من يتصف بالكمال والشمول، لأن الأفكار دائماً بحاجة إلى التطور والتراكم، والسؤال مدخل من مداخل تطوير نظام المعرفة والتفكير والتأويل. ونحن لا نعني بهذا، أن الناس مفطورون على السؤال والتساؤل، ولكن ما نريد قوله، إن حياة الإنسان الحقيقية مرهونة بقدرته على استعمال عقله، لكي يكتشف الحقائق بنفسه، ويعرف الحدود الفاصلة بين القضايا والأمور، بين الوسائل والغايات، بين ما هو كائن وما ينبغي أن يكون. وكلما ارتفعت حقيقة استخدام العقل لدى المجتمعات الإنسانية، كانوا هم أقرب إلى النجاح والسعادة. فلا تنمو المجتمعات حضارياً إلا بالمزيد من استخدام العقل، لأنه وسيلة النمو، وهو الذي يمنح المجتمعات ماء الحضارة وعصب التقدم.
ولاشك بأن السؤال، ومواجهة بديهيات الحياة الاجتماعية بالنقد والمساءلة، هما جزء من منظومة استخدام العقل. وبهذا المعنى يكون (السؤال بالمعنى العام والحضاري) هو عصب الحياة والأفكار. فلا حياة بلا تساؤل، كما أنه لا أفكار ناضجة وحيوية بدون نقد وتقويم وتطوير.
ولا يمكننا أن نقارب أي ظاهرة من ظواهر الاجتماع والوجود بلا تساؤل، فهو لازمة لمختلف الظواهر، ومن دونه لا وجود لثقافة تريد أن تشق سبيلها إلى الدينامية والفعالية.
الإبداع في المختلف
السؤال والنقد يؤسسان لعملية انفتاح وتواصل على المستويين الثقافي والإنساني، وأي تجاوز لهذه الحقيقة فإنه يفضي إلى العديد من المآزق وعلى المستويات كافة. وبفعل هذا السلوك المنغلق والانعزالي والبعيد عن الحس الحضاري والديني السليم، يحدث الانفصال الشعوري والنفسي، وتتشكل كيانات اجتماعية مغلقة، وممانعة لأي صيغة للوحدة والاندماج. وقد لا نبالغ إذا قلنا أن العديد من الحروب الداخلية والأهلية التي شهدتها بعض المجتمعات العربية والإسلامية، وبصرف النظر عن مبرراتها التاريخية والسياسية، هي من جراء تراكم العقلية المتعصبة، التي لا ترى إلا لوناً واحداً وفكراً واحداً وحقيقة واحدة.
إن هذه العقلية بمتوالياتها النفسية والاجتماعية والسياسية، هي جذر العديد من الحروب الداخلية، إذ أنها بمثابة الحاضن لكل الأسباب والعوامل، التي تعمق الإحن والأحقاد، وتشعل الفتن والنزاعات، وتغلّب جوانب العنف والتصعيد، على جوانب التهدئة والحلول السلمية. فالعقلية الدوغمائية، تسعى إلى تأكيد خصوصياتها، حتى لو كان هذا التأكيد على حساب مصالح الأمة والوطن.
وبدل أن تمارس الأفكار والقناعات الثقافية وظيفة تربوية وروحية مهذبة للأخلاق العامة، ومحفزة على الالتزام بالقيم العامة التي تقوي أواصر الوحدة الاجتماعية.
تتحول هذه الأفكار إلى مادة للتأطير الضيق والتنميط والانغلاق، وتبرز الموروثات الاجتماعية والتاريخية في صورها السلبية والمتخلفة، وتبرز عوامل الانعزال واستخدام العنف (عنف القول والفعل) ضد الآخرين. بينما من يتأمل جوهر الأفكار الإنسانية، يجدها تتجه إلى تربية الإنسان إلى الالتزام بالقيم الإنسانية العامة التي لا تشكل عامل نفرة بين الاتجاهات المختلفة، بل عامل وحدة وائتلاف، وتقوي هذه الأفكار آفاق السلم المجتمعي، وتعزيز الضمير الإنساني والرقابة الذاتية والاندفاع الطوعي نحو ممارسة الصلاح والخير على مختلف المستويات.
وفي هذا الإطار، لابد من القول إن العقلية الدوغمائية هي التي تفرغ الدين والقيم العليا من استهدافاتها النبيلة تحت دواع وحجج عصبوية مقيتة. والمشكلة الحقيقية التي تواجه العالمين العربي والإسلامي اليوم، ليست في تربص أعداء الأمة وسعيهم الحثيث لنهب ثرواتنا والقضاء على مقومات وجودنا الذاتي المستقل. بل في تلك العقلية التي لا ترى إلا قناعاتها، وتمارس في سبيل ذلك عمليات الإقصاء والنفي والقتل إلى كل الثقافات والقناعات الأخرى.
إن هذه العقلية تلتقي موضوعياً مع أعداء الأمة التاريخيين، لأنها هي التي تهيئ الظروف في المحصلة النهائية لنجاح مشروعات ومخططات الأعداء، وذلك لأنها تغذي الأحقاد الداخلية، وتمنع الائتلاف وأشكال الوحدة المختلفة، وتحارب بلا هوادة الآخرين الذين لا يتفقون أو يشتركون معها في القناعات والأفكار، فتعم الفتن وتزداد العصبيات، وتتراجع قيم العقل والحضارة. وهذه هي الأرض الخصبة لنجاح أي عدو خارجي في نهب ثروات الأمة والانتقاص من استقلالها وحيويتها الحضارية.
من هنا نرى من الأهمية بمكان، أن يعتني الفكر العربي والإسلامي، بمسائل التنوع والتعدد وقيم التسامح والعدل وآليات تحقيقهما، ويخوض بشكل جاد في أسئلة العصر وتحديات المعاصرة. فلا يكفي الرجوع إلى فكر المقارنات والمقاربات الذي صاغه مفكرو القرن الماضي، إذ أن هذه الصياغات كانت محكومة بعقلية التمامية والدفاع عن الذات، وإن حقائق الاجتماع البشري قد وجدت من عهود تاريخية قديمة، وإن البشر لا يصنعون الحقيقة، وأن دورهم ووظيفتهم هي فقط في أن يعثروا عليها.
لاشك أن مواجهة أسئلة العصر وفق هذا المنظور وهذه العقلية، يزيدنا اغتراباً، ويعمق في نفوسنا عقداً ومركبات نقص عديدة، بعضها صريح والبعض الآخر يختفي تحت «يافطات» وعناوين أخرى. ومن المؤكد أن حقل الاجتهاد الفقهي والمعرفي، هو الذي يفتح إلينا العديد من الأبواب والآفاق، حتى يتجه فكرنا المعاصر إلى تأصيل أسئلة العصر في واقعنا الاجتماعي والحضاري.
ولا مجال في هذا الإطار لإنكار واقع التنوع الفكري والثقافي والمعرفي، فهذا التنوع هو من الحقائق البديهية في الاجتماع الإنساني. ولعل من الخطأ الجسيم النظر إلى هذا التنوع وحق الاختلاف باعتباره عقبة تحول دون إنجاز الغايات النبيلة، ولا ريب أن العمل على ترذيل الاختلاف ونبذه المطلق، لا ينهي الأسباب الطبيعية للاختلاف، وإنما يغير مسارها ويجعلها سبباًمن أسباب النزاع والصراع، بدل أن يكون وسيلة من وسائل الإثراء الفكري والمعرفي. فلا يمكن لقوة الغلبة والقهر من نفي الحقوق الطبيعية في حياة الإنسان، ويأتي في مقدمتها حق الاختلاف.
ومن الطبيعي القول، إن القهر والقسر والإلغاء أشد خطراً وضرراً على الأمم والأوطان من ممارسة حق الاختلاف والاعتراف بالتنوع المعرفي الثقافي، واعتباره الوليد الطبيعي لقيمة الاجتهاد وسبيل تعدد الخيارات الفكرية والإستراتيجية في مسيرة الأمة.
المصدر:الوفاق
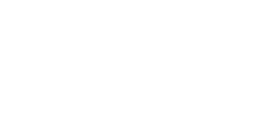
اکتب تعليق جديد