
نحن نترجم، إذن، لأننا نريد أن نرى. أن نرى بعيون الآخرين الذين استطاعوا أن يمعنوا النظر في ما لم نرَ نحن منه شيئاً. من وجهة النظر هذه، تبدو الترجمة وكأنها وسيلة التلاقح الثقافي الأفضل التي تربطنا بالكاتب الموهوب. إنها ثلاثية الأبعاد: تجمع مَن يعلم، بمن لا يعلم، بواسطة إرادة التعلّم. وهو شأن خطير. لأن مَنْ يعلم أكثر منا يحرّضنا بمعرفته. وهذا التحريض المنبثق من القراءة هو الذي سينقلنا من طور إلى آخر نكون فيه أقلّ سذاجة وأكثر علماً. أو على الأقل، هذا هو المأمول منه. لكن الترجمة في الثقافة العربية الراهنة، أو الرغبة فيها، صارت نوعاً من الاستلاب الثقافي المعمم. حتى أننا يمكن أن نقول، بلا وَجَل، إن الكاتب العربي المعاصر يكتب صامتاً، لكنه يصرخ في أعماقه: «تَرْجِموني، تَرجِموني»! كما كتبت سلوى النعيمي، ذات يوم. وبفعل هذه الاستماتة من أجل ترجمة مرغوبة بشدة إلى لغات الغرب بشكل خاص، لغات الاستعمار القديم الذي لا يزال حاضراً بقوة في عقولنا، صارت الترجمة تناقلاً بدلاً من أن تكون تفاعلاً. وهو ما فرّغ النَصّ العربي المترجَم من جوهره، ووضعه في أدنى المستويات مبيعاً ومقروئية. ويكاد لا يشذّ أحد منا عن هذه القاعدة المؤلمة إلاّ في حالات نادرة جداً. نحن نعرف أن الترجمة ليست إشهاراً شكلياً، وإنما هي حمّالة معارف وإشكاليات. لا يجدي استجداؤها، ولا الجري وراءها، لأي سبب كان. لأن مبررها الوحيد هو كون الابداع أصيلاً، يفوق بثرائه ولمُوحاته ما عداه. وهي مسألة فردية بحتة، على العكس من تصوّر المؤسسات الثقافية في العالم العربي، التي تريد أن تزجّ بجحافل من الكتاب في معركة ترجمة مبرمجة، لكنها خاسرة سلفاً، رغم أنها مدفوعة الأجر، ومحتفى بها بشكل لا علاقة له بالأدب. لكأن هذه المؤسسات الثقافية ذات الإمكانيات المادية الباذخة تجهل أن الإبداع، ونقله إلى لغات العالم الحية، «هي أشياء لا تُشترى» كما يقول الشاعر أمل دنقل.
الترجمة حمّالة معارف وإشكاليات
يعود فَشَل المشروع العربي للترجمة، في أحد وجوهه، إلى كونه «مشروعاً أعرج». نحن نعرف أن الثقافة الأدبية العربية معزولة عن الثقافة العلمية.
الفرد المبدع، إذن، هو وحده الذي يستحق الترجمة إلى لغات العالم، وليس الذي تراه هذه المؤسسات اللاثقافية صالحاً لها. وفي هذه الحال، هو غني عن هذه المؤسسات المتسلِّطة، التي تريد أن تستوعبه وتحتويه، أيا كان حسن النية التي تدَّعيه. وهو ما يبدو جليّاً في الشعور القومي الثقافي المتضخّم عندنا، الذي يناقض جذرياً حالة الإبداع الصامتة بالضرورة لأنها تبدع بتأملها وحصافتها، وليس بضجيجها الفارغ. وفي الغرب الذي نطمح بالترجمة إلى لغاته، ليس ثمة شعور قومي للإبداع، وإنما اعتراف عميق بدور الكُتّاب الآحاد، الذين أغنوا الإنسانية بتساؤلاتهم المثيرة للجدل، وشُكوكهم في كل شيء تقريباً، ونقد مجتمعاتهم بحرية وبلا رهبة، وليس بممالأتها، أو التزلّف اللامجدي إبداعياً.
العزلة اللغوية المخيفة بين الآداب والعلوم
وفي النهاية، يعود فَشَل المشروع العربي للترجمة، في أحد وجوهه، إلى كونه «مشروعاً أعرج». نحن نعرف أن الثقافة الأدبية العربية معزولة عن الثقافة العلمية. ففي كل البلاد العربية، باستثناء سوريا، تُدرّس العلوم باللغات الأجنبية بحجج واهية وكاذبة، كما تأكدنا منها بالتجربة في الغرب نفسه. نصف المعرفة إذن لا وجود لها باللغة العربية لا في جامعاتنا ولا في مدارسنا العليا. الكاتب العربي إذن محصور في بيت من غرفة واحدة لا منفذ فيها، هي غرفة اللغة الأدبية الضحلة مهما كانت الصيغ البرّاقة التي يلجأ إليها. وهي بالضرورة لغة عرجاء، فقيرة، ومعزولة، وتتضاءل يوماً بعد يوم، حتى لتكاد أنْ تُهْمَل. وما التزاحم الفج والقبيح حالياً على إنتاج «أدب» لا علاقة له، في الغالب، بمفهوم الأدب، إلاّ نتيجة لهذا الكسر الثقافي العربي العميق. ولا ننسى أن العالم العربي اليوم، هو الوحيد على وجه الأرض الذي تسود فيه مثل هذه العزلة اللغوية المخيفة بين الآداب والعلوم، والذي يلهث، مع ذلك، من أجل ترجمة المكتوب بلغته إلى لغات العالم الحية، عبثاً.
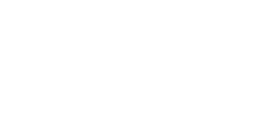
اکتب تعليق جديد