
فسائر شعراء الأندلس وبلاد الغرب الإسلامي عامة، من أمثال الحصري القيرواني وابن زيدون وابن خفاجة وابن حمديس، بل كان لهذا الفن صورته النثرية أيضا، وهي فن المقامة عند بديع الزمان الهمذاني وسائر الذين احتذوه.
على أن هذا استنتاج نأتيه على حذر، نحن نحاول أن تكون لنا منه حصة غير التي اقتطعها المعاصرون من الذين عللوا نشأة «مذهب البديع» تعليلا حضاريا واعتبروه صدى لفن الزخرفة الهندسي، الذي عم كثيرا من جوانب الحياة العباسية من العمارة والفسيفساء والزجاج الملون والنسيج والخط وما إليها من الصنائع. وفي كثير من الشعر العباسي ونثره، تطرد مصطلحات مخصوصة بهذه الصنائع. وليس هذا سوى دليل من بين أدلة أخرى، على وجود علاقة ما بين المحدث الشعري وفنون القرن الثالث للهجرة؛ بل بين هذه الفنون والنقد العربي، كما تدل على ذلك مصطلحات شتى تحدرت إلى النقد من فنون العصر وصنائعه، ومدته بكثير من المفاهيم والمبادئ الجمالية، مثل البناء والصياغة والتسهيم والتوشيح والنسج وما إليها. ويصعب أن نأخذ برأي القائلين إن مفهوم «النص» في ثقافة العرب هو بعكس المفهوم الأوروبي لكلمة Texte التي تعني في جذرها اللغوي النسيج الذي يمكن تفكيكه. وثمة في تراث العرب النقدي أكثر من إشارة إلى العلاقة بين النسج والنص، والعرب كثيرا ما شبهوا الصنعة الكلامية بصناعة النسيج منذ الجاهلية. ولعل نظرية عبد القاهر الجرجاني في النظم، خير دليل لذلك. ويمكن القول إنها تمثل موقف العرب الجمالي العام، إذ هو لا يفصل بين أنواع الفنون المختلفة كالنقش والتصوير والصياغة وما إليها. ومفهومه للنظم إنما تمثل له في كل هذه الفنون ومن بينها فن القول.
إن الاستنتاج الأول الذي نسوقه إذن على حذر هو أن العلاقة بين الشعر والأرابيسك أعمق من أن تختزل في الطابع الزخرفي الهندسي في كليهما، أو في تمكن الزخرف من شعراء البديع، لدافع نفساني جمالي أملته عليهم طبيعة مجتمعهم، إنما هي تتسع لكتابة مستفرغة في كليهما من أي هم إبلاغي، أو هي مجردة من «النفعية»، أو هي تنزع إلى المتعة الخالصة، أو إلى ما يسميه حازم القرطاجني «محاكاة المحاكاة» حيث الصورة الشعرية شأنها شأن الأرابيسك نص «قابل للقراءة» و«غير مقروء» في الآن ذاته. فهي محكومة مثله بعقلية رياضية دقيقة من حيث التناسق والتناظر والتداخل والتشابك والتماثل والتقابل. وهذه من أهم مميزات الأرابيسك، الأمر الذي يجعل قراءة هذه الصور ممكنة. ولم نعدم من القدامى من تأولها واحتال لها؛ وحملها على محاكاة المحاكاة أو بناء الاستعارة على الاستعارة. وهي صور أساسها كتابة «لا نموذجية» أو«لا قياسية» قد لا تعدو دلالتها المتعة الخالصة: متعة تجميع الحروف والعناصر النباتية والأشكال الهندسية في الأرابيسك حيث لا رابط في الظاهر من شكل أو من معنى يسوغ إلحاق حرف بعنصر نباتي أو بشكل هندسي؛ إلا أن يكون ذلك نابعا من أساس الكتابة المادي، وهو أساس الرسم والنقش والتصوير، ومتعة التلاعب بالمستعار منه والمستعار له في الصورة، حيث تتصل الوحدات الصغرى (الأبيات) بوحدات مماثلة لها تجاورها أو تعلوها أو تدانيها، أو بصور متقابلة أو متعاكسة؛ وتنتظم كلها في هيئة واحدة محكومة بنظام هندسي صارم، وعقلية رياضية دقيقة. فلعل الموضوع الرئيس في هذا الشعر وفي الأرابيسك كليهما هو مجلى «روح الكتابة» ذاتها أو«جوهرها»؛ أي الكتابة التي لم تخلص في ثقافة العرب من المثال «الأنطولوجي» بسبب من ارتباطها بالقرآن من حيث هو «الكتاب الأم»، الذي لا يفتأ يذكر الإنسان بأن الكون نفسه كتاب يمكن أن يتآلف في بنية واحدة كلية؛ إذا استطاع أن يفك رموزه وينفذ إلى دلالته على قدرة الخالق وحكمته في المنظور الديني، بل هو يستطيع أن يحتذي هذه البنية إذا استقامت له جودة الآلة وإصابة الغرض المقصود وصحة التأليف والانتهاء إلى تمام الصنعة، أو ما سموه العلة الهيولانية والعلة الصورية والعلة الفاعلة والعلة التمامية.
الاستنتاج الأول الذي نسوقه إذن على حذر هو أن العلاقة بين الشعر والأرابيسك أعمق من أن تختزل في الطابع الزخرفي الهندسي في كليهما، أو في تمكن الزخرف من شعراء البديع، لدافع نفساني جمالي أملته عليهم طبيعة مجتمعهم.
وكان العرب يرون أن هذه الخلال الأربع ليست في الصناعات وحدها، بل هي موجودة في جميع الحيوان والنبات. ومن ثم كانت اللغة عندهم أو «ألفاظ الشاعر» صورة من الهيولي الأولى التي يعنون بها الطينة التي يبتدعها الخالق ليصور ما شاء تصويره من رجل أو فرس أو جمل أو غيرها من الحيوان، أو برة أو كرمة أو نخلة أو سدرة أو غيرها من سائر أنواع النبات. ولا يخفى أن نزعة كهذه تنهل من نبع ديني أو ميتافيزيقي وتقوم على العرفان مقابل البرهان العقلي، تجعل من بلوغ الكمال الجمالي أنطولوجيا ومعرفيا ممكنا، كلما توخى «الصانع أو الشاعر في السياق الذي نحن فيه، إعادة إنتاج أصل معطى له سلفا، أي هذه اللغة أو الألفاظ التي يستجيدها الشاعر ويتخيرها؛ وكأنها مجرد وعاء للفكر أو الشعر، وليست الفكر أو الشعر ذاته. فهو إذن صانع لا يكتفي بأن يتلقى عنه، بل يتلقى هو أولا مادة بنائه فيتخير جيدها ويلفظ رديئها؛ حتى إذا تم له ذلك كان كمن «وجد آجرا وجصا فبنى» بعبارة الفرزدق. وفي هذا وغيره، دليل على الأثر العميق الذي تركته ثقافة «النص» (القرآن) في رؤية القدامى الفنية. ولا يخفى أن «النص» إنما اختص به في التراث العربي الإسلامي القرآن والسنة، على أساس مقابلة خفية أو مضمرة بين الشعر والوحي. فمثلما اصطنع العرب للنفيس من الشعر والمتخير اصطلاح «المعلقة»، اصطنعوا للمعجز الديني اصطلاح «نص»؛ وكلاهما يضمر حكما نقديا أو حكم قيمة. غير أننا قصرنا الإشارة على القرآن؛ لأن استشهادهم به في المدونة النقدية والبلاغية هو المطرد. وكان أن نظروا إلى العمل الفني على أنه احتذاء وصنعة تتعلق بالكلمة (اللوغوس) أكــثر مما تتعلق بالعالم الطبيعي، بل إن هذا العالم نفــسـه صحائف متناثرة و«كـلمة» و«كتاب» يتملى فيه «الصانع المخلوق» قدرة «الصانع الخالق» وحكمته، بل أن الصنعة تشهد، ما ائتلفت في بنية واحدة كلية، للإله الخالق المتعالي الذي لا يوصف ولا يمكن إدراكه، وكأنها برهان على وجوده. ومن هذا الجانب قد يصعب القول بمتعة فنية خالصة في الفن الإسلامي عامة، إذا نحن لم نر فيه إلا هذا العالم المثالي المفارق عالم المطلق الإلهي؛ مع أن المتعة نفسها حقيقة عملية نفعية.
أما إذا أخذنا بالاعتبار أسـاس هذه الكـتـابـة «اللانموذجية» أو «اللاقياسية» في الأرابيسك وفي الشعر، فقد نذهب في قراءتنا أبعد مما ذهب إليه المعاصرون من الذين اختزلوا العلاقة بينهما في الطابع الزخرفي، وجعلوا الشعر صدى للأرابيسك، ولم نجد منهم من كلف نفسه عناء السؤال: ولم لا يكون الشعري هو الذي أثر في الأرابيسك بنسبة أو بأخرى، أو كان من دواعي نشأته؟
على أننا لا نحب أن نتورط في إشكالات الأصل والمبتدأ وما يتفرع عنها من قضايا تأثر الفنون العربية الإسلامية بعضها ببعض. إنما ساقنا إلى هذا الأرابيسك ما نلمسه من صلة لطيفة بينه وبين الشعر القائم على أساس من الاستعارة قديما عند الذين ذكرت، وحديثا؛ حيث الوظيفة الجمالية التخييلية قد تكون الأظهر في هذين الفنين كليهما. وهي وظيفة «الحسن» التي تجمع إلى محيط دائرتها، كل عناصر الرسالة أو الكتابة، وكثيرا ما تحدث في الصنعة جملة من المعاني اللطيفة المستغربة؛ خاصة أن عملها يتسع للصورة بنية ونغما وإيقاعا، الأمر الذي يضعنا في سياق مراوحة بين أشكال «شفهية» وأخرى «كتابية»، ويوقفنا على اتحاد بين «الشكل» و«موضوعه» كما هو الشأن في الموسيقى؛ حتى ليتعذر أن نخلص هذا من ذلك، ولو على مقتضى إجراء منهجي. ففي الأرابيسك تصرفنا الصورة عن العناصر الطبيعية إلى زخرفة محورة عن الطبيعة، أساسها مزج الطبيعي بالخيالي. وكأن مسعى الفنان يكمن في تحرير هذه العناصر من سلطان المادة «الفانية» بتحويرها وفق نظام هندسي خاص مظهرا وتكوينا. وفي الشعر يمكن أن نلحظ هذا المسعى في أكثر من صورة محكومة بظاهرتين لافتتين: قابليتها للانشطار والتفرع، من جهة، وتجمع عناصرها وأجزائها بشكل دائري حول نواة واحدة، من جهة أخرى. ولعل هذا المظهر في إنشائية الصورة أن يكون على وشيجة بعنصرين زخرفيين في الأرابيسك هما: المروحة النخلية والزهرة. وهو ما أعود إليه بشيء من التفصيل، مستأنسا بمدونة بعض الشعراء العرب المعاصرين مثل الفلسطيني نمر سعدي والتونسية أفراح الجبالي.
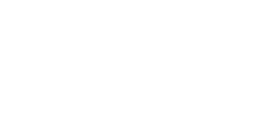
اکتب تعليق جديد