بالإمكان أن نبدأ بالتساؤل عن الأدب وعن الفلسفة قبل الخوض في تمحيص هذا التساؤل بمثل ما يكون ذلك في عرف الفلاسفة. لكن ما فائدة اجترار استفهام لن ينتج عنه أمر جديد سوى تعليق يسبق أو يجر جملة تعليقات حول موقف أو جملة مواقف. لقد بحث الفلاسفة هوية انتمائهم وتساءلوا عن الفلسفة كما فعل دولوز تماما مثلما فحصوا جوانب السؤال ما الأدب؟ ومنهم جان بول سارتر - وهو أحد الوجوديين الذين جسدوا خير تجسيد انصهار الأدب بالفلسفة - الذي تطرق بعمق للإجابة عن هذا السؤال من خلال كتابه: ما الأدب؟ وفيه تناول بالرد عن التساؤلات الأساسية وإن كان هدفه الأكبر توضيح صلة الأدب بالالتزام لكنه بشكل واضح على القضايا الآتية:
موضوع الكتابة من جهة ماهيتها أو ما الكتابة؟ لماذا نكتب؟ ولمن نكتب؟
إذن كان بالإمكان أن تكون بداية مقاربتنا للاستفهام المطروح في العنوان من هذه النقطة التي تتخذ من الأدب مثار سؤال لنكشف عن جوهره وخلفياته وأبعاده عن تاريخيته وعن أدواته وأساليبه، عن أنطولوجيته وغائيته. لكنني أتجاوز هذا السؤال من دون تقديم مبرر كما يوجب ذلك فعل التفلسف الذي سيفقده معناه.
يتضح بداية أن مدلول الكتابة يقربنا من مفهوم النص. فليست هناك فلسفة من دون كتابة والأمر نفسه ينطبق على الأدب. فلا فلسفة ولا أدب من دون نص. هذا الإقرار من الطبيعي أن يحيلنا على مسألة التناص لكننا نستبعد هذه المسألة من ورقتنا على الرغم من أهميتها لأننا بصدد إجلاء علاقة الفلسفة بالأدب والكتابة والنص. ربما اعترض أحدهم على هذا الرأي بمثال سقراط الذي لم يترك نصا أو واحدة من الأساطير أو الروايات التي تروى شفاهة غير أن هذا الاستثناء أو ذاك لا يمنعنا من تأكيد القاعدة العامة في الكتابة لكل الفلسفة والأدب. والحقيقة أن سقراط أراد من خلال فلسفته أن يصير نموذجا يطبق فيه المعرفة من زاوية نظرية على سلوك أخلاقي واقعي وبالتالي فالفلسفة بحسبه هي فن في الحياة أو طريقة حياة وعيش تنصهر فيها الرؤية الأنطولوجية مع الأخلاق والإستيطيقا. كما أن الشفاهة في الأسطورة أو الرواية لا تمنعنا من الإقرار بالكتابة التي يرتبط معناها بمرحلة متقدمة من تاريخ الكائن البشري وخاصة في تطوير اللغة واستخدام أدوات في التدوين وانتشار الطباعة. لقد جاءت الكتابة لتبعث الحياة في الرواية الأصل – الشفاهية وتمددها في الذاكرة.
أن الفلسفة وبناء على أسطورة العقل والمنطق - ادعت أنها رائدة قطاعات الثقافة (الفكرة الموروثة عن عصر الأنوار وعن كانط بالتحديد الذي نصب الفلسفة قاضيا وحارسا على الثقافة) وأنها من دون الأشكال التعبيرية الإنسانية الأخرى الوحيدة القادرة على إدراك ماهيات الأشياء وبلوغ لباب المشاعر وتبريرها بلغة العقلانية لذا فلا العلم ولا الأدب ولا الفن ولا الدين بمقدورهم أن ينجحوا في هذه المهمة أمام الفلسفة. خطأ النقد الأدبيين أنهم انساقوا وراء هذا الزعم وأخذوه مأخذ الجد ومن ثمة ذهبوا إلى مجاراة المذاهب الفلسفية ليستلهموا منها ما يعزز طروحاتهم.
يمكن القول أن الأدب من حيث تفتح وتحقق ذاتي يطابق الغريزة والعاطفة والفلسفة من حيث تجربة وتعقل مطابقة للعدالة والغائية.
في الوقت الذي توصف فيه الفلسفة بأنها فن أو بأنها علم أو حتى أحيانا أخرى علما وفنا في آن واحد، لا يثير هذا الوصف أي اعتراض من قبل الفلاسفة لكن حالما تحاول بعض الأصوات وهي قليلة جدا تخطي الحدود التي حاولت بعض النبرات فرضها وتبريرها إلا وتجدهم ينتفضون ضد مثل هذا الموقف.
فإذا كان معروف منذ القديم، أن فلاسفة هاجموا الأدب ورفضوا إدراج وقبول الشعراء بينهم ودعوا إلى طردهم (مثال أفلاطون قديما فالفلسفة لدى هؤلاء جهد فكري واستدلال منطقي صارم قبل أن يكون آلية في الوصف أو تقنية في التدوين إلا أن هناك من سعى إلى التقريب بينهما إلى درجة المزج والتداخل فلا فلسفة من دون أدب والعكس صحيح ويكفي هنا أن نورد مثال التوحيدي فيلسوف الأدباء وأديب الفلاسفة كما لُقب أو حديثا مع فلاسفة الوجودية سواء الذين انحازوا إلى اللغة الشعرية كما هو شأن مارتن هيدغ أو مع سارتر وكامي اللذين صاغا أفكارهما الفلسفية في شكل رورايات ومسرحيات زادت من رواج فلسفتهما وأوصلتها إلى آفاق أبعد ربما مما لو صيغت بقوالب تقليدية كما هو شأن النصوص الفلسفية التي هي على تلك الشاكلة.
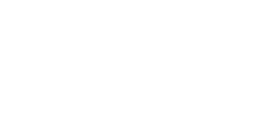

اکتب تعليق جديد