
السؤال رغبة في العلم، أما التساؤل فهو أسلوب في التعلم. ولا يكاد يوجد مفكر عربي وصلتنا مؤلفاته مملوءة بالأسئلة والتساؤلات مثل أبى حيان التوحيدي، صحيح أن الحارث المحاسبى (ت 243هـ ) وضع كتابه “الرعاية” في صورة سؤال منه وإجابة من شيخه (المجهول)، وصحيح أيضًا أن الحكيم الترمذى (ت 285هـ) قد طرح بدون إجابة (155) سؤالا حول موضوع الولاية، وظلت أسئلته مطروحة على الجميع إلى أن أجاب عنها محيى الدين بن عربي (ت 638هـ) في موسوعته الكبرى “الفتوحات المكية” . لكننا مع التوحيدي نلتقى بنزعة غالبة في طرح الأسئلة، وإثارة التساؤلات، بل بفن متكامل يمكن أن نطلق عليه “فن السؤال والتساؤل”.ومن المقرر أن لكل فن أصولاً وقواعد، كما أن له غاية وأهدافاً، وهو دائمًا مرتبط بفلسفة عامة يصدر عنها، ويتحرك في إطارها .
وإذا كان السؤال يعبر عن استفهام مباشر يطرحه التوحيدي على أحد أساتذته أو زملائه ليتلقى عنه إجابة محددة، كما فعل مع مسكويه (421هـ) فإن التساؤل يتم طرحه على النفس، أو كما فعل التوحيدي على أحد أساتذته الذين لا يمكننا أن نتأكد تمامًا من أنهم قد أجابوه عنه، أو حتى نتأكد من أنه قد طرح عليهم أساسًا تلك الأسئلة، كما فعل مع السجستانى (ت حوالى 38.)(1) .
وأنا أميل إلى الشك في أن التوحيدي قد سأل السجستانى بالفعل كل هذه الأسئلة، كما أشك في أن السجستانى قد أجابه عنها بتلك الصورة، وأذهب إلى أن كلاً من الأسئلة والإجابات معًا هى من صنع التوحيدي. ومن أقوى الأدلة على ذلك ما نجده من نضج في الأسئلة، يتجاوز مستوى التلميذ الذى يسأل لكى يعرف، بل إنها أقرب إلى أسئلة الصح في المخضرم الذى يكون على دراية تامة بالموضوع، ثم يختار شخصية مشهورة لكى يجعلها تنطق بما يريد(2). كذلك فإن الملاحظة الدقيقة للغة السؤال والإجابة تكشف عن نقاط تشابه كثيرة .
تؤكد كلها أنها من صنع شخص واحد (وأنا هنا أدعو إلى إجراء دراسة أسلوبية تهدف إلى استخراج البصمة اللغوية للتوحيدي، ومقارنتها بأساليب الشخصيات التي أورد لها أقولاً في مؤلفاته).
المعروف أن السؤال يطرحه الإنسان على ذوى الخبرة والمعرفة ليجيبوه عنه، وأن التساؤل هو السؤال الذى يطرحه الإنسان على نفسه، إما مندهشًا أو متحيرا أو أحيانًا متهكمًا – وقد استخدم التوحيدي الأسلوبين معًا. أما السؤال فكان مع فيلسوف الأخلاق مسكويه(3) .
ومسكويه فيلسوف معروف ومشهور. وآراؤه مبسوطة في كتبه التي وصلتنا بعضها. وأما التساؤل فقد استخدمه التوحيدي باسم السجستانى(4)، وكان من هؤلاء المثقفين الكبار الذين يميلون إلى إشاعة التنوير عن طريق الجلسات والمنتديات أكثر مما يركزون على تأليف الكتب والرسائل، وربما كانوا أكثر علمًا وثقافة من المؤلفين المحترفين(5) .
ويبدو لى أن التوحيدي قد استغل اسم هذه الشخصية الثقافية الكبيرة ليقدم من خلالها تصوراته وآراءه ووجهات نظره في شتى مجالات المعرفة والثقافة في عصره، إلى جانب أخلاقيات المجتمع وسلوكياته. وذلك مثلما فعل أفلاطون عندما قدم آراءه ونظرياته من خلال أستاذه سقراط. وهكذا فإن أسئلة التوحيدي – التي طرحها بصفة خاصة على السجستاني – ليست أكثر من تساؤلات أي أسئلة مطروحة على النفس، استخدم فيها اسم السجستاني كما استخدم أفلاطون في محاوراته اسم سقراط(6) .
لماذا يلجأ المفكر إلى أسلوب السؤال والتساؤل؟ هناك عدة أسباب، ويمكن أن تكون كلها أو بعضها وراء ذلك. فهناك أولاً: حساسية الدهشة المفرطة لدى بعض المفكرين الذين يقفون من الكون والأحداث والبشر موقف الاستغراب، أو محاولة الوصول إلى حقائق الأشياء، وعللها البعيدة(7). وهناك ثانيًا: الشعور بالخشية من مواجهة الجو السائد في المجتمع ببعض الآراء التي تخالفه، أو تصدمه، وبالتالي تثير الغضب على صاحبها .
وهناك ثالثًا: الرغبة في تعليم الآخرين، والأخذ بأيديهم من حالة الجهل واللامبالاة إلى حالة المعرفة والاهتمام، ثم هناك أخيرًا: إحداث الصدمة الضرورية في بيئة تسيطر عليها المقولات الجامدة، والخطاب القاطع الوحيد .
إن الثقافة عندما تنتشر في مجتمع ما قد تتحول في لحظة معينة، وبفعل عوامل محددة، إلى حالةمن الاستقرار الذى يكرس الثبات والتقليد والنمطية. وهنا لابد من أن تجدد الثقافة نفسها، بظهور بعض المفكرين الذين يفتحون في هذا الجدار السميك ثقبًا، أو يلقون في تلك البحيرة الراكدة بحجر. و في هذه لحالة، يعتبر كل من السؤال والتساؤل مدخلاً ضروريًا لتحريك السكون، ودفع الواقفين إلى مواصلة المسير، وإقلاق راحة الواثقين !
لقد دارت أسئلة التوحيدي وتساؤلاته حول النفس البشرية، وأسرار الوجود، وخفايا اللغة، كما لمست أخلاق الناس، وتعرضت لمناهج التفكير، وتناولت علاقة الفلسفة بالدين، وصلة الأصيل بالوافد، أو المحلى بالعالمي. و في هذا الإطار قد لا تكون الإجابات مهمة بنفس القدر الذى ينبغي أن تكون عليه الأسئلة والتساؤلات، وذلك لسبب بسيط هو أن الإجابات تختلف في قوتها وضعفها، وتتفاوت في صحتها واستمرارها، ولكن الأسئلة والتساؤلات تظل محتفظة بقيمتها، وخاصة عندما تدور حول القضايا الرئيسية المتصلة بالإنسان والكون والمصير.
لقد اشتهر التوحيدي بما سبق أن أطلقه عليه (ياقوت) في معجم الأدباء بأنه أديب الفلاسفة وفيلسوف الأدباء، وتنازعه الدارسون في مجالي الأدب والفلسفة. والواقع أن التوحيدي يمثل في الثقافة العربية نموذجًا يوجد أمثال له في الثقافات الأجنبية. وقد حاول الباحث الموسوعي الكبير عبد الرحمن بدوى أن يقيم علاقة تشابه بين التوحيدي وكافكا في مجال التشاؤم، والنزعة العدمية(8) .
ولكنني أختلف معه في ذلك. ف التوحيدي يدور في إطار بينما كافكا متحرر من أي إطار، و التوحيدي مؤمن يحيره الشك أحيانًا، ولكن قلب كافكا فارغ من الإيمان، وأخيرًا فإن التوحيدي يرتكز على مجموعة من المبادئ الأخلاقية والاجتماعية في حين أن كافكا يسعى إلى هدمها من الأساس .
و في حدود معرفتي بالثقافة الفرنسية، أقول باطمئنان إن دور التوحيدي في الثقافة العربية يتشابه إلى حد كبير مع دور ميشيل دى مونتاني M.ntagneفي الثقافة الفرنسية(9)، وهو الدور الذى يتمثل فيما يمكن أن نطلق غليه “إعادة النظر” في كل ما يحيط بالإنسان، مع الغوص في أعماقه للبحث عن أصل الوجود، وأسرار الكون، وختام الحياة. ومن الواضح أن “إعادة النظر” تتطلب عينًا تتوقف أمام المألوف على أنه غريب، وأمام العادى على أنه نادر مدهش، كما أنها ليست عينًا بطيئة الحدقة، تنظر في اتجاه واحد، بل هي عين واسعة الرؤية تنتقل بين العديد من الأشياء، وبسرعة كبيرة، وأحيانًا خاطفة .
كيف يمكن للمثقف الجاد أن يعيد النظر فيما حوله؟ بوسائل متعددة، من أكثرها فعالية استخدام طريقة السؤال والتساؤل، التي كان يتقنها التوحيدي، موظفًا طاقته الأدبية في حسن الصياغة، وتشقيق الكلام، وحشد المترادفات التي تمتلئ بها لغة غنية مثل اللغة العربية. يقول التوحيدي: “يا هذا! قد صرفت لك القول في فنون من العبارة، على ضروب من الإشارة”(1.) وعدم التنبه لذلك هو الذى أدّى بكثير من الباحثين إلى تصنيف التوحيدي في مجال الأدب، مع أنه لا يستخدم الأدب وأدواته المتاحة في عصره إلا كوسيلة للتعبير عن أفكاره الفلسفية، أو بمصطلح أدق: نزعته الفكرية والأخلاقية .
لقد كان التوحيدي بدون شك يملك نفسًا متطلّعة إلى المعرفة، وروحًا موسوعية تهدف إلى الإلمام بكل شيء، ولعل هذا هو السبب الذى جعله ينفر – في مطلع حياته من العزلة التي هي طابع المفكرين المتأملين، ويسعى بكل نشاط إلى المشاركة فيما يمكن أن نطلق عليه “الصالونات الأدبية” التي ازدهرت في عاصمة الخلافة، خلال القرن الرابع الهجري (11). وميزة هذه الصالونات أنك تلتقى فيها بالثقافة الحيّة، والأفكار التي تشغل الناس في حياتهم اليومية. لكنها من ناحية أخرى تضم إلى جانب رجال الفكر الرفيع: أدعياء العلم ،والمتفيهقين بالمعرفة، وأصحاب المنصب والثروة الذين يرغبون في استكمال وجاهتهم الاجتماعية برعاية الفنون والآداب. وهنا يجد المثقف الجاد نفسه في مأزق حقيقي: فإما أن يجارى الزيف، والنفاق، والمظهرية، وإما أن ينسحب من الميدان تاركًا كل شيء. وهذا ما فعله التوحيدي في آخر حياته .
لقد قيل إنه قد انتهى من رحلة الرغبة العارمة في المعرفة، والشك والحيرة، والسؤال والتساؤل – يائسًا أو مستسلمًا، والدليل على ذلك ما نقرأه في آخر مؤلفاته “الإشارات الإلهية”(12) – الذى هو عبارة عن أطول مناجاة بشرية لله تعالى في اللغة العربية، وربما في سائر اللغات الأخرى. وفيه يقول: “إذا ضللت عن حكمة الله فقف عند قدرته، فإنه إن فاتك من حكمته ما يشفيك، فلن يفوتك من قدرته ما يكفيك(13). ويقول أيضًا: “ويحك! كيف تحكم بـ لم على خالق لم؟ أم كيف تحتج بالحجة على مظهر الحجة؟ أم كيف تدل بالعقل على منشئ العقل؟ أم كيف تباهى بالعلم واهب العلم؟ .
ولكننا هنا ينبغي أن ننبه إلى أمر هام، وهو أن حالة الاستسلام عن إدراك الحقيقة، أو إجابة الأسئلة والتساؤلات التي تظهر بوضوح تام عند التوحيدي في آخر مؤلفاته – لا يصح تعميمها على “المعرفة الإنسانية” بكل فروعها. فهو يقول بصراحة “إن الله وهب لك هذا الإحساس (جمع حس يعنى حاسة) لتعتبر بها فيما ترى، وتسمع، وتذوق، وتشم، وتلمس”(15) وإذن فالمقصود من الاستسلام هو العجز البشرى عن الاحاطة بأبعاد القدرة الإلهية في سموها وتعاليها. يقول التوحيدي: “من توجه إلى الله استسلم”(16) وهذا ما نجده عند كبار فلاسفة الصوفية على مر العصور .
فإذا انتقلنا بعد ذلك إلى دراسة أولية لأسئلة التوحيدي، وجدنا أهم مؤلفاته في هذا الصدد، وهو كتاب (الهوامل والشوامل)(17) الذى طرح فيه (175) سؤالاً على مسكويه. وأول ما نلاحظه على تلك الأسئلة هو مدى التنوع الشديد فيما بينها. فهي تدور حول الإلهيات والطبيعيات والإنسانيات. وتلك هي الدوائر الثلاث، التي إذا أضيف إليها دائرة الرياضيات تمثلت أمامنا الموسوعة الفلسفية في إطارها الكلاسيكي، التي وصلت إلينا من الإغريق .
وكما تختلف أسئلة التوحيدي في مجالاتها السابقة، فإنها تتراوح بين البساطة والعمق. فهناك الأسئلة السهلة التي يمكن أن ينشغل بها عامة الناس، وإذا سمعها أي إنسان تطلع إلى معرفة الإجابة عنها (بل من الممكن جدًا أن تستغلها حاليًا، أي مجلة معاصرة لتجذب بإثارتها القراء) ومن ذلك مثلاً :
1-لماذا تواصى الناس بكتمان الأسرار، وتحرجوا من إفشائها، ومع ذلك لم تنكتم ؟
2-ما السبب في اشتياق الإنسان إلى ما مضى من عمره ؟
3-لم قبح الثناء في الوجه، وحسن في المغيب؟
4-لم صار بعض الناس إذا سئل عن عمره نقص في الخبر، وآخر يزيد على عمره ؟
5-لم صار البنيان إذا لم يسكنه الناس تداعى عن قرب، وما هذا هو إذا سكن واختلف فيه؟
6-لم صارت غيرة المرأة على الرجل أشد من غيرة الرجل على المرأة ؟
وإلى جانب أمثال هذه الأسئلة البسيطة، أو التي تبدو كذلك، نلتقى بأسئلة أخرى تؤدى مباشرة إلى ما نطلق عليه “التفلسف”، أى تأمل أحداث الحياة من منظور فكرى يسعى للفهم، ومحاولة إزالة الغموض أو التناقض عن المعنى الكلّى للحياة والكون، ومن ذلك :
1-ما وجه الحكمة في آلام الأطفال، ومَنْ لا عقل له من الحيوان ؟
2-ما علة كثرة غم من كان أعقل، وقلة غم من كان أجهل في الأفراد والأجناس .
3-لم كلما شاب البدن شبّ الأمل؟ وهل اشتمل الأمل على مصالح العالم؟ وإن كان مشتملاً فلم تواصى الناس بقصر الأمل، وقطع الأماني ؟
4-لم اشتد عشق الإنسان لهذا العالم حتى لصق به، وآثره، وكدح فيه، مع ما يرى من صروفه ونكباته وزواله بأهله ؟
5-لم كان فرح الإنسان بنيْل ما لم يحتسبه ويتوقعه أكثر من فرحه بدرك ما طلب، ولحوق ما زال ؟
6-لم صار اليقين إذا حدث وطرأ لا يثبت ولا يستقر؟ والشك إذا عرض أرسى ورض (أى استقر) ؟
ثم إن هناك مجموعة من الأسئلة، تتجه إلى تفسير الظواهر والتغيرات الطبيعية، وتستدعى بالتالى نوعًا من المعرفة التجريبية، وحثًا عليها. ومن ذلك :
1-ما الحكمة من وجود الجبال ؟
2-لم صار البحر في جانب من الأرض ؟
3-لم صارت مياه البحر ملحًا ؟
4-لم كان صوت الرعد إلى آذاننا أبطأ وأبعد من رؤية البرق إلى أبصارنا ؟
5-على ماذا يدل انتصاب قامة الإنسان من بين سائر الحيوان ؟
وأخيرًا، هناك مجموعة من الأسئلة تشير – بصورة غير مباشرة – إلى نقد اجتماعى، وتعبر بذاتها عن موقف أبى حيان نفسه من بعض الظواهر والمفارقات التي تحدث في المجتمع، وتنتشر في الحياة الثقافية، ومن ذلك :
1-ما بال أصحاب التوحيد لا يخبرون عن البارى إلا بن في الصفات؟
2-ما الفرق بين العرافة والكهانة والتنجيم والطرق والعيافة والزجر؟ وهل تشارك العرب في هذه الأشياء أمة أخرى؟
3-ما علة كراهية النفس الحديث المعاد؟ وما سبب ثقل إعادة الحديث على المستعاد؟ وليس فيه في الحال الثانية إلا ما فيه في الحالة الأولى؟ فإن كان بينهما فارق فما هو ؟
4-لم صار الإنسان إذا صام أو صلى زائدًا على الفرض المشترك فيه حقر غيره، وتكبر حتى كأنه صاحب الوحى، أو الواثق بالمغفرة والمنفرد بالجنة، وهو مع ذلك يعلم أن العمل معرض للآفات التي تحبطه وتجعله هباء منثورًا؟
ولعل من أوضح الأمثلة في هذه المجموعة ما نجده في السؤال التالي، وما ألحقه به التوحيدي من تعليق حاد، يكاد يصادر به على الإجابة المطلوبة، إن كان الأمر – من وجهة نظره – يحتاج إلى إجابة :
5-ما الذى سوّغ للفقهاء أن يقول بعضهم في فرج واحد: هذا حرام، ويقول الآخر فيه بعينه هذا حلال؟ وكذلك المال والنفس؟ كلام هذا يوجب قتل هذا، وصاحبه يمنع من قتله. ويختلفون هذا الاختلاف الموحش، ويتحكمون هذا التحكم القبيح، ويتبعون الهوى والشهوة، ويتسعون في طريق التأويل، وليس هذا من فعل أهل الدين والورع، ولا من أخلاق ذوى العقل والتحصيل. هذا وهم. يزعمون أن الله قد بين الأحكام، ونصب الأعلام، وأفرد الخاص من العام، ولم يترك رطبًا ولا يابسًا إلا أودعه كتابه، وضمّنه خطابه!
والذى يعيد تأمل هذه المجموعات التي سبقت من الأسئلة سوف يلاحظ قاسمًا مشتركًا بينها جميعًا، وهو أن السؤال يتجه إلى محاولة التعرف على (علة) الشيء، أو (حكمته)، ولذلك يستخدم فيها أداة الاستفهام (لم)، وحتى عندما يستخدم أداة أخرى مثل (ما) فإنها تلحق مباشرة بكلمة (علة) أو (حكمة). ومن المعروف أن البحث عن العلة كان وما يزال هو الطابع (العام) للفلسفة، بينما اتجه العلم إلى البحث عن الكيفية، أي خصائص الشيء وصيرورة هذه الخصائص من أجل الاستفادة المباشرة منها .
لكن السؤال الفلس في، من ناحية أخرى، حين يتجه إلى البحث عن العلة، لا يكون عامًا في كل الأحوال. فهناك العلة القريبة والمباشرة والعلة البعيدة أو الغائبة. والفيلسوف حين يطرح أسئلته لمعرفة العلل القريبة فإنه يقدم خدمة جيدة للعلم، وخاصة في مجال نشأة الظواهر، وتتابعها، أو اتصال بعضها ببعض .
كذلك فإن هناك من الأسئلة الفلسفية ما يعد نوعًا من (التحليل العقلي) الذى يساعد في التعرف على بعض جوانب الظاهرة أو جزئياتها، وذلك بالإضافة إلى أن معظم الأسئلة الفلسفية تهدف إلى (التركيب العقلي) أى وضع الإجابات الصغيرة والمبعثرة حول ظاهرة ما في إطار كلى شامل .
ويبقى أن السؤال الفلسفي في يحمل في ذاته دعوة إلى البحث، والتعرف، والاكتشاف. وهو بذلك كله يمهد البيئة المناسبة للبحث العلمي الذى يمكنه أن يسترشد بعلامات الاستفهام الفلسفية ليحدد الأرض التي يقيم عليها بناءه .
من هنا، ينبغي أن ندرك قيمة الدور التمهيدي الكبير الذى آداه التوحيدي للثقافة العربية عن طريق استخدام السؤال والتساؤل، وما يمكن أن يحدثه ذلك من تحريك السكون، وغربلة المتوارث، وفتح آفاق جديدة ومتجددة للمعرفة .
لقد كان على العلماء – حينئذ – أن يبدأوا العمل من تلك البيئة الجديدة التي أعدها لهم التوحيدي، وكان على من أتى بعده من المفكرين أن يكونوا أكثر جرأة واقتحامًا، وكان من الضروري أن يستمر إنتاج الأسئلة وطرح التساؤلات حتى لا يخيم شبح الركود، والمسلمات القطعية التي لا تقبل نقاشًا، ولا تتحمل إعادة النظر !
لكن ماذا حدث للثقافة العربية بعد التوحيدي ؟
عادت الغلبة لاستقرار الحلول السابقة التي أبدعها الأجداد في ظروف مختلفة، وتكونت هالات التقديس حول كثير من الأسماء غير المعصومة من الخطأ، واستعان كثير من العلماء بالسلطة الزمنية لفرض آرائهم على مجرى الحياة، بدلاً من أن يتركوا تلك الآراء لقانون التجربة، وما يفرضه من معايير الصواب والخطأ. و في مجال التعليم الذى يسبق الثقافة ويمهد لها – صار التلقين والحفظ والشرح والتلخيص هي الأعمدة الأساسية التي يقوم عليها صرح الثقافة العربية. وإذا كانت المقدمات تؤدى دائمًا إلى نتائجها، فقد كان من أهم هذه النتائج: اختفاء الإبداع، ومحاربة التجديد، وغياب روح الدهشة، وضمور فن السؤال والتساؤل .
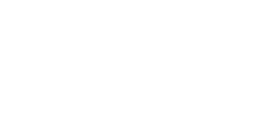
اکتب تعليق جديد