
كلمة للشيخ مصطفى قصير في مؤتمر المناهج التربوية نظمه مركز الامام الخميني
المناهج التربوية في العالم الإسلامي- معالم الخطة الأميريكية وآليات المواجهة
المحور الثالث- الموضوع الثاني:
مساهمات المدارس الإسلامية في صياغة منهج أصيل
دور المدرسة الإسلامية في تأصيل الثقافة وتحصين الأمة:
من أهم الأهداف التي من أجلها كانت المدرسة الإسلامية هو العمل على تحصين الساحة التربوية والثقافية في مقابل محاولات التغريب والتشويه الثقافي، والعمل على بناء أجيال تحمل الإسلام المحمدي الأصيل بوعي وإدراك إلى جانب العلم والمعرفة.
والأصالة هنا مقابل الهجانة والتشويه، فعندما نتحدث عن إسلام أصيل نعني به الإسلام المأخوذ من النبع الصافي غير الملوَّث، لأنه دين إلهي، والدين الإلهي يعتمد على الوحي وعلى النبوة، وهو بلا شك لا يقتضي السلفية والجمود كما قد يتوهم البعض.
كما أن من المهم الإشارة في البداية إلى أن المدرسة الإسلامية الحديثة دخلت الساحة التربوية في لبنان منذ فترة زمنية غير بعيدة قياسياً، فلم يمض أكثر من عقدين على تشكّل أول مدرسة إسلامية بالمعنى الدقيق للكلمة، وبالتالي فإن التجربة لا زالت حديثة العهد ولم تكتمل بعد، خاصة أنها ولدت في ظروف من التحديات والصعوبات وبالقليل القليل من الإمكانيات، إلا أن مجالات التطوير والنمو والارتقاء لا زالت قائمة.
وهذه التجربة على تواضعها لها أهمية كبرى ستتضح عند الحديث عن الإنجازات.
لكن من الجدير بالذكر، أن الإنسان قد لا يلتفت إلى أهمية أو حساسية بعض الخطوات أو البرامج إلا من خلال ردة الفعل الكبيرة تجاهها من قبل الأعداء والمتضررين منها، فنحن اليوم عندما نرى إصرار الإدارة الأمريكية على إدراج تغيير المناهج التربوية ضمن خطوات مشروعها للهيمنة على العالم اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وإعلامياً، نعرف مدى أهمية هذه المناهج ودورها الفاعل في تشكيل حالة الممانعة والإعاقة لتلك الهيمنة، وبالتالي فهي قادرة على إيجاد الحصانة الثقافية والفكرية والأخلاقية التي تحول دون الاستجابة لإرادة الغازي ودون القبول به، بل تقاوم استيراد الأفكار والثقافات التي صيغت بدقة لتخدم طموحات وأغراض وسياسات الأعداء، ولتمهد النفوس للقبول بمشاريعهم والتبعية التامة لهم.
هذا يعني أننا لا نستغني في مواجهتنا لمخططات الهيمنة الأميركية على عالمنا بل على العالم أجمع، لا نستغني عن الجبهة التربوية والثقافية لأنها هي القاعدة وهي الأساس والمنطلق لكل أشكال التصدي والمقاومة.
وهذا يستدعي منا العمل على محورين:
المحور الأول:
التعامل بحذر شديد مع كل المناهج التي تورَّد إلينا مباشرة من أمريكا أو تتسلل تسللاً بطرق متعددة إلى ساحتنا التربوية، فقد ثبت أنهم يسعون لإلباس مناهجهم ثوباً محلياً من ناحية الظاهر، وعلى مستوى الشكل والإخراج، لتسهيل عملية التسلل وعبر شركات محلية كما يحصل بالفعل، على طريقة الأنشطة الاستخباراتية والأمنية تماماً، لكن في عالم الثقافة والتربية بدلاً من السياسة والأمن. مما يتطلب الدقة والحذر واليقظة التامة، وعدم الانخداع بالمظاهر الخارجية التي تخفي وراءها كل الأغراض البعيدة.
وهنا يجدر الالتفات إلى أن بعض هذه المناهج قد يغري التربويين بحداثة الأسلوب والتقنيات والمنهجية، وقد لا يظهر ما يريدون بشكل واضح في الكتاب، لأن بعض مراحل التغيير التي تسلك أحياناً تبدأ بفك الارتباط مع مناهجنا نحن والارتباط بمناهجهم، ثم تأتي المراحل اللاحقة لتحمل معها ما يريدون زرعه، وقد يكون المطلوب قد وضع بشكل خفي أو ترك للمساعِدات والمتمِّمات التي يعتمدها المعلم أو غير ذلك من الأساليب.
المحور الثاني:
إيجاد البدائل المناسبة من خلال العمل الجاد على تطوير المناهج المحلية والقائمة على ثقافة أصيلة، على صعيد المحتوى والمنهجية والتقنيات والأدوات، مع المحافظة على الأصالة والدقة في إدخال القيم والمواقف والأهداف التربوية ضمن الكفايات الأساسية المقصودة، وتدريب الأجهزة التعليمية بما يمكِّنهم من العمل على تحقيقها في ساحة الدرس.
وبعبارة أخرى فإن أهم وسائل المواجهة هنا تتمثل في ملء الفراغ بما يحقِّق الحاجة وبما يفوِّت الفرصة على العدو لاستغلال الفراغ.
إنجازات المدرسة الإسلامية في لبنان خلال العقدين الأخيرين:
رغم حداثة التجربة يمكن القول أن المدرسة الإسلامية حقَّقَت عدة إنجازات في مجال تأصيل الثقافة والتربية وأهم ما أنجزته ما يلي:
1-فتحت الباب واسعاً أمام المزاوجة بين الدين والعلم وأبرزت حالة التكامل بينهما، على خلاف ما كان يُعمل على زرعه في أذهان الأجيال في الماضي من دعوى التعارض والتنافي بين الدين والعلم، مما دفع الكثير من الناس آنذاك للتخلي عن الدين ووصفه بالرجعية والتخلف، بينما ألجأ آخرين إلى التخوف من العلم.
ولكن الحقيقة أثبتت أن الدين الأصيل يدعو للعلم، والعلم يدعّم الإيمان، ولا يستغني عنه، إذ أن الدين يقوم بعملية الوصل بين نتائج العلوم المادية والعوالم المجردة أو ما وراء الطبيعة، ويربط الأشياء بأصولها ومبادئها، والأنظمة الكونية والسنن الطبيعية بمُجْريها وواضِعِها، حيث يعجز العلم بنفسه القيام بذلك.
كما أن العلم كلما تقدّم وتطوّر وأنتج للإنسان قدراتٍ جديدةً كلما زادت الحاجة للثروة الكبيرة من قيم الدين ومناهجه السلوكية التي هي وحدها القادرة على أن تحول دون استخدام نتائج التطور العلمي في الإفساد بدلاً من الإصلاح وفي التدمير بدلاً من الإعمار وفي القضاء على الإنسانية بدلاً من تعزيزها.
فالمدرسة الإسلامية من شأنها أن تؤسس لمنهجٍ متوازنٍ يضع التطور العلمي في الطريق الصحيح والسليم.
2-أتاحت المدرسة الإسلامية الفرصة للتعرف على الأديان السماوية ومبادئها وثقافاتها دون تشويه ودون اجتزاء، فحقّقَت فرصة متوازنة للطالب الذي كان في السابق يسمح له برؤية جانب من الحقيقة في أحسن الأحوال، ويسمع عن الدين من الطرف الآخر فيرى الأشياء من نافذة ضيقة، فتبهره أمور واقعها لا يبهر، وتنفره أمور أخرى واقعها لا ينفّر، لولا ذلك الاجتزاء أو التشويه.
3-قدَّمت المدرسة الإسلامية للطالب بيئة تربوية وإجتماعية سليمة نوعاً ما، تساعده على النمو بعيداً عن عوامل الفساد والانحراف الأخلاقي وتعينه على الالتزام بالقيم والأخلاق الإنسانية والإسلامية، ولا شك أن التربية من خلال المثال الصالح والقدوة الحسنة أكثر نجاحاً، كما أن البيئة الاجتماعية والأسرية لها كبير الأثر على إنجاح العملية التربوية، فالمدرسة الإسلامية تتولى تشكيل ذلك عندما تعمل على اختيار أساتذتها ومعلميها وتضع أنظمتها وأنشطتها بما يتناسب مع هذا الهدف.
لكن لا نخفي الصعوبات التي كانت ولا زالت تواجه المدرسة على هذا الصعيد مع غياب الجامعات ودور المعلمين التي من شأنها تخريج الأجهزة البشرية القادرة على أداء هذه المهمة الخطيرة والتي تحمل معها رؤية واضحة وقدرة فنية عالية، فتركت المدرسة الإسلامية تقوم بنفسها بإعادة تأهيل أجهزتها البشرية وفق حاجاتها وبحدود إمكانياتها المتواضعة، فنجحت تارة وأخفقت أخرى.
4-على مستوى المناهج (فيما عدا منهج التربية الدينية) قدّمت المدرسة الإسلامية حتى الآن مساهماتٍ متواضعةً في التأليف وفق الرؤية المتقدمة، لكنها مارست دوراً ترميمياً لجوانب الخلل والقصور وأكملت ما أتيح لها إكماله من جوانب النقص، وحذفت ما ينبغي حذفه ليأتي المنهج متناسباً في الحد الأدنى مع المبدأ الذي انطلقت منه.
المساهمات المنتظرة والمتوقعة في المستقبل
هنا، لا بد من الحديث عما يمكن للمدرسة الإسلامية القيام به ولو مستقبلاً بعد أن تذلّل العقبات وتوفّر الإمكانات اللازمة، تصبح هذه المساهمات أكثر إلحاحاً في ظل المخططات الأميريكية الرامية إلى إحداث تغييرات في المناهج التربوية في دول العالم الثالث تخدم أهدافاً توسعية تقوم على أساس التغيير الثقافي:
1-بإمكان المدارس الإسلامية أن تتعاون على تشكيل إطار تجمُّع لها يقع على رأس اهتماماته تكوين رؤية موحدة تسوّق في دوائر التخطيط والقرار التربوي الرسمي في لبنان للتأثير على مسار الأنظمة والقرارات التربوية الرسمية بما يوجد سداً في مواجهة الهيمنة الأميركية على المناهج التربوية في لبنان.
وهذا أمر ممكن لأن المدارس الإسلامية التابعة لمؤسسات أو التابعة لأفراد باتت بمجموعها تمثّل كتلة لا يستهان بها، خاصة إذا استفادت من الثقل السياسي لحزب الله، وإذا تمكَّنَت من توسيع دائرة التأييد في أوساط المدارس التابعة لطوائف أخرى.
ولا بد من الإشارة إلى أن واقع المناهج التربوية في لبنان، في ظل غياب الرؤية الثقافية الأصيلة عند السياسيين، جاءت في كثير من الأحيان استنساخاً للمناهج التربوية الغربية، وليس هناك أدلّ على هذا الواقع من سياسة التعامل مع اللغات الأجنبية التي تعتبر لبنان بلداً ثنائي اللغة بل ثلاثيّها، وهذا الأمر انعكس سلباً على اللغة العربية.
هذه ليست دعوة للتخلي عن اللغة الأجنبية، وإنما هي إلفات إلى ضرورة التعامل معها وفق رؤية وسياسة تقوم على فهم دقيق للهدف والمراحل والقدرات.
2-الدخول إلى عالم تأليف ونشر الكتاب المدرسي الذي يراعي الشروط والمواصفات الحديثة ويجسّد الثقافة والمرتكزات الفكرية والأخلاقية والقيمية الأصيلة ويعتمد منهجية تربوية متقدمة.
ليست المشكلة اليوم في توفّر الخبرة أو الأجهزة البشرية، بل في كيفية الاستفادة من هذه الخبرات وآلية استثمارها، فنحن قادرون على منافسة ما يطرح، وبالتالي توفير الكتاب المدرسي الملائم من حيث المضمون والأسلوب والإخراج والوسائل المساعدة والمكمِّلَة، وما إلى ذلك، شرط توفير الإمكانات المادية واللوجستية، وهذا الموضوع له أولوية كبرى في الوقت الحاضر.
3-بإمكان المدرسة الإسلامية إذا اعتمدت التوزيع على أساس الكفايات أن تدخل في الكفايات الخاصة بكل صف وبكل مادة القيم الإسلامية والإنسانية المتناسبة، والتي يتم اختيارها بدقة فائقة لتلائم المرحلة العمرية والمادة الدراسية، ويوضع لها طريقة تربوية مؤثرة ونشاطات متناسبة من شأنها أن تنتقل باهتمامات المدرسة من المجال المعرفي إلى المجال السلوكي التربوي، وهذه الخطوة يمكن تطبيقها في عرض الكتب والمناهج الحالية كمشروع ترميمي وتكميلي. إذا حصل هذا فمن شأنه أن يحدث تغييراً جذرياً في النظرة إلى دور المعلم واهتماماته التربوية، ولكنه يفترض وجود مهارات خاصة عند المعلّم ينبغي اكتسابها وتأهيله عليها ليصبح قادراً على أداء الدور بنجاح.
4-على مستوى التربية الدينية التي كانت البداية في إطلاق المناهج التربوية الإسلامية، حتى الآن اقتصرت غالباً على المجال المعرفي التلقيني، ولذا، عجزت عن تأدية دورها المطلوب بالشكل الكامل، فمن الواجب توسيع دائرة اهتمام المنهج ليدخل فيه كفايات تتجاوز المجال المعرفي إلى المجال الوجداني والسلوكي العملي وتحديث الطرائق المعتمدة ليدخل فيها من النشاطات ما يجعل الطالب يكتشف ويحلّل ويتخذ موقفاً ويتعاطف ويبني سلوكاً والتزاماً تجاه كل ما يمر به في المنهج.
إن تحديث التربية الدينية في المنهج والطريقة والوسائل بات أمراً ضرورياً جداً، خاصة مع المقارنة بالمناهج الحديثة التي تمتلك قدرة على الجذب وإثارة الاهتمام وتفعيل دور المتعلم على حساب التلقين.
أضف إلى ان المرحلة الثانوية التي تمثّل مرحلة التشكُّل الفكري للطالب تكتسب حساسية فائقة، مما يعني ضرورة تلبية المنهج لاحتياجات المرحلة مع مراعاة الدقة في صياغة المجال الفكري والعقائدي بحيث يعالج كل القضايا التي تثير اهتمام الشاب، وتجيب على تساؤلاته.
في الختام.. أجد أن عقد مثل هذا اللقاء – بحد ذاته- يمثِّل خطوة بالاتجاه الصحيح، لأنه يعبِّر عن مستوى الإحساس بالخطر ويضعنا جميعاً أمام المواجهة الصعبة، ولكي لا يكون المؤتمر مجرد صرخة ينبغي أن يتبع بلقاءات عملية تأخذ النتائج والتوصيات إلى ميادين العمل والخطط والبرامج.
والله من وراء القصد
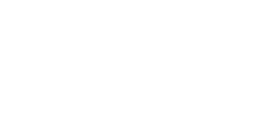
اکتب تعليق جديد